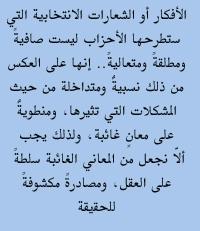يتابع المواطنون والمواطنات باهتمام شديد التجاذبات والحوارات الجارية بين القوى السياسية على طريق التحضير للانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في إبريل عام 2009 م، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين إضافيين، وتأجيل الانتخابات حتى إبريل القادم 2011م.. وفي الطريق إلى صندوق الاقتراع تقترب لحظة الحقيقة، بعد أن تجاوزت الديمقراطية الناشئة في بلادنا محاولات تأجيل العملية الانتخابية من قبل بعض أحزاب (اللقاء المشترك) التي لا تخفي رغبتها في التأجيل إلى أجل غير محدد.. بيد أن المؤتمر الشعبي العام وقف بحزم ضد هذه الرغبة التي كان الهدف الأساسي منها إدخال البلاد في فراغ دستوري وأزمة سياسية عامة تتيح لأحزاب المعارضة فرصة التسلل إلى السلطة والمشاركة فيها عبر الأبواب الخلفية، وبعيداً عن إرادة الناخبين وصناديق الاقتراع!! مما له دلالة عميقة أن يتزامن الاستعداد لهذه الانتخابات مع حراك سياسي مفعم بالحوارات والتحالفات والتجاذبات والاستقطابات والمزايدات التي استنهضت مفاعيل العملية الديمقراطية داخل المجتمع، وأحدثت تحولاً نوعياً في المشهد السياسي والحزبي العام لجهة التغيرات الحاصلة في خارطة الإصطفافات والتحالفات والمواقع، فيما تضاعف سجل الناخبين على نحو ٍ يؤهـَـّـل الانتخابات البرلمانية القادمة للانطلاق بالمسيرة الديمقراطية الى ذرى جديدة، وتمكينها من التفاعل مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم. لا يعني ما تقدّم خلوّ الطريق الى صندوق الاقتراع من بعض العوائق والمخاطر والتحديات التي تستوجب عملاً مثابراً من كافة القوى السياسية لإزالتها، وصولاً الى تأمين الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، الأمر الذي يضع على عاتق هذه الأحزاب واجب الاتفاق على ميثاق شرف انتخابي يـُلزم الجميع بالابتعاد عن العنف والأعمال الخارجة عن القانون أثناء العملية الانتخابية، والامتناع عن استخدام المساجد والمال العام والوظيفة العامة لأغراض الدعاية الانتخابية والصراعات الحزبية والمكايدات السياسية.. وتغمرنا ثقة عميقة في قدرة وحرص الأحزاب السياسية على تحويل مُدخِلات العملية الإنتخابية ومُخرَجاتها الى تراكم جديد يُضاف الى صرح الديمقراطية في بلادنا.. وبقدر نجاح هذه الأحزاب في خوض أنتخابات سلمية وشفافة، بقدر نجاحها في تطوير الثقافة السياسية الديمقراطية وترسيخ قيمها في حياة المجتمع. صحيح ان ثمة رواسب للثقافة الشمولية والنزعات الأحادية التسلطية ما زال ت تمارس تأثيرها في وعي وسلوك بعض النخب الحزبية والسياسية القديمة، التي يستهويها خطاب الشعارات والمُطلقات، وتشتغل على التبشير بالأفكار، بدلاً من الاشتغال على البحث عن الحقيقة وإنتاج المعرفة واكتشاف عالم الحقيقة الواقعي.. لكن هذه الرواسب والنزعات الموروثة تظل غير قادرة على مصادرة الميول الموضوعية لتطور المجتمع اليمني باتجاه الديمقراطية التعددية، وإنضاج ثقافتها السياسية والتخلص من بقايا الأفكار القديمة ورواسب العادات والتصورات التي ارتبطت في الماضي بطرائق التفكير والعمل الشمولية القديمة، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتجاهات الجديدة التي تكونت بين صفوف الشباب داخل بعض الأحزاب السياسية الفاعلة، على طريق إعادة اكتشاف الواقع وصياغة مهمات قابلة للتحقيق.. بمعنى المراهنة على الفوز بالمستقبل، والتوقف عن الاشتغال على أوهام الإقامة الدائمة في الماضي! ثمة متغيرات مهمة ونوعية حدثت في المشهد السياسي العام للبلاد منذ أول انتخابات قائمة على التعددية الحزبية عام 1993م.. فقد تبدلت خارطة الاصطفافات والتحالفات والمواقع على نحو مثير للدهشة والتأمل، فيما تضاعف سجل الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في العملية الانتخابية الى ما يقارب عشرة ملايين ناخب وناخبة، وهو ما يؤهل الانتخابات البرلمانية القادمة لتدشين منعطف تاريخي في خبرة الممارسة الديمقراطية والحياة السياسية عموماً. ويزيد من أهمية الانتخابات القادمة التي تتهيأ لها البلاد انها تتم في ظروف محلية وإقليمية وعالمية تتسم بالتأثير المتزايد لقيم الديمقراطية والحرية والمشاركة في تقرير مصائر الشعوب والأمم والمجتمعات، وتعاظم الميول الرافضة للاستبداد والتسلط والهيمنة والارهاب، سواء على مستوى العلاقات بين النظم السياسية ومجتمعاتها، أو على مستوى العلاقات بين الدول والحكومات في إطار المجتمع الدولي. ومن نافل القول ان ثمة عوامل داخلية وخارجية تـُضفي على الانتخابات القادمة أهمية نوعية تقتضي تخليص العمل السياسي من رواسب الأفكار والعادات والعلاقات الموروثة عن الحقب الشمولية السابقة، وصياغة مهمات قابلة للتحقيق، والابتعاد عن المتاجرة بالشعارات الشعبوية والمكايدات السياسية والمزايدات اللفظية.. ولعل التحدي الكبير الذي يجعل من الانتخابات القادمة اختباراً صعباً في مدرسة الديمقراطية هو مدى قدرة الأحزاب السياسية وفاعليات المجتمع المدني على تفعيل قوة القانون بدلاً من التعاطي مع قانون القوة، وما يترتب على ذلك من ضرورة نبذ ثقافة العنف ورفض الأعمال الخارجة عن القانون أثناء العملية الانتخابية، وعلى وجه الخصوص في مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت والفرز.. وبقدر نجاحنا في خوض مباريات انتخابية خالية من العنف والأعمال غير القانونية، بقدر نجاحنا في إنضاج العملية الديمقراطية الجارية في البلاد، وتجذير قيمها في الحياة السياسية للمجتمع. لا أبالغ حين أقول ان الأحزاب السياسية كلها مطالبة بعبور حقل الألغام الذي ينتظرها في الطريق الى لحظة الحقيقة يوم السابع والعشرين من ابريل 2011م القادم ، حيث يتوجب تخليص الخطاب السياسي والإعلامي الحزبي من رواسب ثقافة القمع والإقصاء والأحادية التي تمارسها الأحزاب بدون استثناء وبصورة متبادلة تحت شعار الدفاع عن الحريات ومقاومة الممنوعات. من حق كل حزب ان يمارس حريته في نقد الجميع، وعرض أفكاره وتسويق مشروعه السياسي بحرية تامة.. كما أن النقد يفقد وظيفته الحرة حين يتحول من نقد الآخر الى نقضه، أي الى إلغائه.. و لعل أهم ما يميز النقد عن النقض هو أن الأخير يلغي الأول، امّا النقد فإنه لا يـُلغي شيئاً، بل يفتح أفقاً حراً للتفكير، ويساعد على تغيير شروط العلاقة مع الآخر والاستماع الى الآراء والأصوات التي لم يكن مسموحاً الاستماع إليها بيد أن النقد لا يتم في الفراغ بل يشتغل على أفكار ومشاريع وأدوات تتصل بالواقع وتسعى الى تغييره في آن واحد، وهو أمر لا يمكن حدوثه بدون التحرر من ديكتاتورية الشعارات التي تتمركز حول الذات وتتمترس وراء الأفكار. لا أتهم حزباً أو مجموعةً من الأحزاب بديكتاتورية الشعارات والتمركز حول الذات وحراسة الأفكار.. فالجميع عرضة للوقوع تحت طائلة هذا الخطر الذي يعد عدوّاً لدوداً للعقل والحرية والحقيقة.. فلا يكفي ان يتداول أي حزب سياسي خطاباً إنتخابياً يكشف عن هويته السياسية او الفكرية او العقائدية، لأن الذي يقرر هوية هذا الحزب او ذاك هو نمط علاقته بذاته وبغيره، الى جانب طريقة تعامله مع الواقع والأفكار والأحداث. لا ريب في ان الحياة السياسية العربية حفلت بمفارقات مذهلة خلال النصف الأخير من القرن العشرين المنصرم.. فثمة وسطيون مارسوا الوسطية بتطرف.. كما ان هناك تقدميين طبقــّوا مشاريعهم التقدمية ثم أوصلوا مجتمعاتهم الى أوضاع أكثر رجعيةً وتأخراً وتخلفاً.. وهناك أيضاً قوميون وحدويون كرسوا التجزئة والطائفية والتشرذم الداخلي بممارساتهم ((القومية الوحدوية))..فيما تورط بعض الاسلاميين بتقديم نماذج استبدادية اساءت الى الإسلام والمسلمين وغير المسلمين في المناطق التي أقاموا عليها إمارات اسلامية في أفغانستان والعراق والصومال وغزة والسودان وموريتانيا والمغرب والجزائر ونيجيريا ومالي و وادي سوات بباكستان، ثم تفرغوا بعد ذلك للصراع والقتال فيما بينهم من اجل غنائم السلطة ومفاسد الدنيا، حيث قاموا بإقصاء وتصفية بعضهم بعضا من خلال استخدام العنفً بعد ان أقصوا الآخرين من قبل.. إن جميع هؤلاء كانوا نسخاً من بعضهم البعض، ولذلك اشتركوا في مشاريع فاشلة شهدت على أن القواسم التي جعلتهم يلتقون في ((مشروع مشترك)) هي ضيق الأفق والتعصب العقائدي وقصور الأدوات المعرفية والاغتراب عن الواقع والتاريخ والعالم، وصولاً الى العجز عن اكتشاف الأبعاد المتنوعة للحقيقة. ستجري الانتخابات القادمة على قاعدة جديدة من الاصطفافات والتحالفات التي أزالت المسافات بين أعداء الأمس الذين أصبحوا اليوم حلفاء وأصدقاء، وهذا شيء محمود ولا تثريب عليه.. لكن الدرس الذي لا يجوز تجاهله هو ضرورة الاعتراف بأن المشاريع الحزبية والايديولوجية القديمة احترقت.. وإن أفكارها البالية فقدت جاذبيتها ومصداقيتها.. وعليه يجب ألا يغيب عن بال الجميع ان الناس لن ينخدعوا بالوعود والشعارات إذا لم يتخل أصحابها عن إضفاء القداسة على الأفكار والمشاريع السياسية التي يبشـّرون بها ويدعون اليها، لأن الذين يقدسون أفكارهم وأحزابهم ومشاريعهم السياسية يكونون اول ضحاياها، سواء تغنت بالوطن او الأمة أو الدين أو الثورة أو الاشتراكية.. وأكثر السياسيين والمثقفين العرب الذين أخقفوا وانتقدوا ماضيهم، كانوا من المدافعين عن نـُظم ٍ لم يكن لها من شاغل ٍ سوى التنكيل بخصومهم وتصفيتهم!! ما ينبغي على الأحزاب أن تتداركه هو تجنب الوقوع في خطاب المـُطلقات الذي يستهوي الأحزاب العقائدية غالباً، ومعظم أحزابنا من النوع العقائدي الذي يشتغل على الدعوة بدلاً من المعرفة والبحث عن الحقيقة.. ومن واقع تجارب الشعوب العربية مع الأحزاب العقائدية أصبح الحذر يلازم هذه الشعوب تجاه كل من يرفع شعارات الحرية ومكافحة الفساد والتصدي للغرب ((الصليبي)) والتحرر من (( التبعية )).. فليس كل من يرفع شعاراتً فضفاضة قادراً على تطبيقها.. وليس كل من يدعو الى فكرة يزعم انها الحقيقة المطلقة قد أصبح موضعاً للثقة المطلقة بموجبها!! يخطئ من يعتقد ان بإمكانه استخدام الديمقراطية كوسيلة للوصول الى السلطة وإعادة إنتاج تجارب الأحزاب الشمولية العربية في الحكم، ومعظم أحزابنا امتداد لها وإستعادة لذكراها واشتغال على أفكارها وشعاراتها ونماذجها.. كما يخطئ أيضاً من يعتقد بإمكانية استخدام الديمقراطية المعاصرة بهدف الإقامة الدائمة في العصور الوسطى، وإعادة إنتاج نصوصها وأصولها ونماذجها وأدواتها.. ان التعامل مع التجارب الشمولية في خطاب معظم أحزابنا يتم دائماً في نطاق (اللقاء المشترك) بين المُطلقات المشتركة التي تختفي خلف شعارات ((الدفاع عن مصالح الأمة.. محاربــــــة الإمبريالية.. التصدي للغزو الصليبي.. الدفاع عن الوطن.. مواجهة اعداء الأمة وعملائهم.. حراسة الدين ومواجهـــــــــــــة الكفر)).. ومن نافل القول ان المطلق يقود دائماً الى الأحادية والاستبداد والارتهان للماضي! ليست الأفكار او الشعارات الانتخابية التي ستطرحها الأحزاب صافية ً ومُطلقة ً ومتعاليةً.. انها على العكس من ذلك نسبية ومتداخلة من حيث المشكلات التي تثيرها، ومنطوية على معان ٍ غائبة، ولذلك يجب الا نجعل من المعاني الغائبة سلطة ً على العقل ، ومصادرة ً مكشوفةً للحقيقة، الأمر الذي يفرض على الجميع ــ وبدون استثناءــ واجب تحويل التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة الى مناسبة لتعلـّـُم فن الحوار والاختلاف بين شركاء لا أعداء.. بين فواعل تعمل تحت الضوء من أجل التغيير واستشراف المستقبل ومواجهة ثقافة العنف التي تمهد للارهاب.. بين أبعاد متعددة لحقيقة نسبية لا يحتكرها أحد. صحيح ان ثمة تجاذبات حزبية وسياسية أحاطت بطرق تناول خطر ثقافة العنف على وعي وسلوك المتأثرين بهذه الثقافة التي تجسدت في أشكال مختلفة من التعبئة الخاطئة لضحاياها، بيد ان هذه الثقافة المشوهة لاتنحصر فقط في الخطاب السياسي الذي تورِّط فيه بعض رجال الدين والدعاة المشتغلين في الحقل السياسي، إذ ْ ان هؤلاء يمارسون نشاطاً سياسياً وحزبياً بامتياز، رغم محاولة التماهي مع مشروعية دينية لا تحظى بإجماع كافة قوى المجتمع المدني، خصوصاً وإن الضالعين في توظيف الدين لأغراض سياسية بحتة، يمارسونه من خلال أطر حزبية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يتيح لكافة قوى المجتمع السياسية وفاعلياته الفكرية والثقافية فرص التمتع بكافة الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية التي يكفلها الدستور للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الصحافة والحق في تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام الآليات الديمقراطية للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم السياسية، وتداول السلطة او المشاركة فيها سلمياً من خلال الانتخابات المباشرة والحرة التي تشارك فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير الحكومية والمواطنون والمواطنات عموماً. ولمـّا كان قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يمنع قيام أي حزب او تنظيم سياسي على أساس الادعاء باحتكار تمثيل الدين أو الأمة أو الوطن، انطلاقاً من حرص المُشـرَّع على سلامة الممارسة الديمقراطية، ومراكمة المزيد من التقاليد والخبرات التي تصون مرجعية الأمة كمصدر للسلطة، فإن أي ادعاء باحتكار تمثيل الدين أو استخدامه لممارسة وصاية غير مشروعة على الدولة والمجتمع، يعد تجاوزاً خطيراً للدستور الذي ينظم قواعد الممارسة السياسية، وإنتهاكاً خطيراً لمبادئ الديمقراطية وقيمها، الأمر الذي يلحق ضرراً بالأسس الدستورية للنظام السياسي القائم في البلاد، ويفسح الطريق لزعزعة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار.ويبقى القول أن مستقبل الديمقراطية الناشئة في اليمن يتوقف على مدى النجاح في إنضاج المزيد من شروط نطورها اللاحق، عبر مراكمة خبرات وتقاليد تؤسس لثقافة سياسية ديمقراطية، وتمحو من ذاكرة المجتمع رواسب الثقافة الشمولية الموروثة عن عهود الاستبداد والتسلط والأحادية، بما تنطوي عليه من نزعات شمولية تقوم على الإقصاء والإلغاء والتكفير والتخوين والزعم باحتكار الحقيقة، وعدم قبول الآخر ورفض التعايش معه، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف الى تسويق مشروع استبدادي غير قابل للتحقيق بالوسائل الديمقراطية، ويبرر بالتالي العدوان عليها من خلال استخدام العنف بوصفه المقدمة الأولى للإقصاء والانفراد.[c1] *عن صحيفة (26 سبتمبر )
|
فكر
في الطريق إلى لحظة الحقيقة
أخبار متعلقة