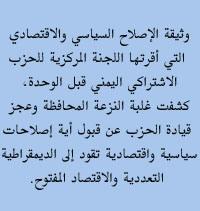طبول المواجهة بين المناطق الرمادية والزوايا الحادة
كنت قد تطرقت في المقال السابق إلى ضرورة نقد وتفكيك بنية الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب اللقاء المشترك كمدخل لفهم طبيعة الأزمة التي تعيشها هذه الأحزاب . كما تناولت في السياق نفسه الاهتمام المفاجئ الذي أبدته مؤخرا صحف أحزاب “ اللقاء المشترك “ وأخواتها لنقد التعديلات التي جرت على مواد دستور دولة الوحدة بعد حرب 1994 لجهة شطب المواد المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنة المتساوية وتأكيدها على أن الديمقراطية لا يحميها دستور يخلو من الاعتراف بالمواطنة المتساوية ,ومما له دلالة عميقة أن هذه الانتقادات ارتبطت بكثرة المقالات والتناولات حول الوحدة وظروف تحقيقها والتشكيك بشرعيتها ، الأمر الذي يطرح عددا من التساؤلات المشروعة حول مصداقية ما يطرحه الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب “ اللقاء المشترك “ في المسائل المتعلقة بالوحدة والديمقراطية والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا المحورية في هذا الخطاب على نحو ماتناولناه في المقالات السايقة . وعليه فإن نقد وتفكيك بنية هذا الخطاب يستوجب إعادة طرح كل التساؤلات السابقة بما فيها القضايا المحورية والهامشية التي يتضمنها بدءا بقيام الوحدة حتى اليوم .دشّن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م بداية عهد تاريخي جديد في مسار الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة للشعب اليمني، إذ جاء الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية لينهي عقوداً من التجزئة والتشطير والتوترات الداخلية ، التي تركت ظلالاً ثقيلة على شكل ومضمون الحراك السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي للمجتمع اليمني.وزاد من أهمية توحيد الوطن سلمياً ارتباطه بولادة أول نظام سياسي ديمقراطي تعددي ، يتيح ظروفاً أفضل لتشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق الحريات المدنية وإقرار مبدأ سيادة الأمة وحقها في انتخاب هيئات السلطة بواسطة الاقتراع الحر والمباشر على طريق تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة.لا يسعى كاتب هذه السطور الى البحث في تاريخ التحول نحو الديمقراطية في بلادنا منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، بقدر ما يستهدف مقاربة مصادر الخلل والتناقضات والأزمات التي حدثت في مجال ممارسة السياسة على مستوى الدولة والسلطة والمجتمع.. ولا ريب في أن إجراء هذه المقاربة ضروري كخطوة على طريق البحث عن أليّات معرفية لإعادة بناء الفكر السياسي في اليمن، وتجاوز الإشكاليات والمصاعب الناجمة عن حداثة التحول نحو الديمقراطية، وهي إشكاليات ومصاعب لا يمكن فهمها من خلال النظرة التبسيطية التي تختزلها في تناقض مفترض بين سلطة تنزع إلى تقييد الممارسة الديمقراطية، ومعارضة نذرت نفسها للدفاع عن الديمقراطية ونظامها القيمي.من نافل القول أن إعلان قيام الوحدة وتدشين التحول نحو الديمقراطية تحققاً بإرادة سياسية مشتركة من قبل قيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني اللذين كانا يحكمان شطري البلاد قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م، ولا يقلل ذلك من أهمية الدعم الواسع الذي قدمه الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية ومنظماته الجماهيرية لهذا المشروع الوطني التاريخي .. بمعنى أن القوى المحركة لهذا المشروع سواء على مستوى النخب الحزبية الحاكمة في شطري البلاد قبل الوحدة، أو على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية، كانت ومازالت تنتمي إلى منظومات فكرية وسياسية متعددة ومتباينة، لكل منها جهازه المفاهيمي الذي يشكل وعيه ورؤيته ومواقفه واستعداداته في مختلف القضايا المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، بما في ذلك طريقة فهمه للعالم الخارجثمة من يقول إن توافق الإرادة السياسية لقيادتي الشطرين سابقاً في تبني مشروع الوحدة والديمقراطية لم يكن بعيداً عن العوامل المؤثرة في البيئة الإقليمية والعربية المحيطة باليمن، حيث وصلت الدولة القطرية إلى ذروة أزماتها المتمثلة بالعجز عن مواصلة التنمية التي اصطدمت بعدة عوائق أهمها فشل نماذج الاقتصاد الموجه والاقتصاد الاشتراكي في بعض البلدان العربية، وغياب الحريات السياسية والمدنية في بلدان عربية أخرى أخذت بنظام اقتصاد السوق، بالإضافة إلى مأزق الانكفاء داخل حدود الدولة القطرية.ويربط أصحاب وجهة النظر هذه بين تزامن أزمات التنمية والديمقراطية في العالم العربي من جهة، وبلوغ الأزمة الاقتصادية في البلدان الاشتراكية بسقوط الاتحاد السوفيتي وإنهيار المنظومة الاشتراكية الدولية من جهة أخرى، إلى جانب التحول التدريجي للصين من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر والإقتصاد المزدوج .ما من شك في أن تزامن إعلان قيام الوحدة مع التحول الديمقراطي شكل إسهاماً يمنياً متميزاً في إثراء الجدل الذي ساد في أوساط النخب السياسية والفكرية العربية خلال الثمانينات، حول إشكاليات تحقيق الوحدة العربية وحاجة المجتمع العربي للديمقراطية ، بعد أن وصلت مسيرة الكفاح التحرري الوطني ضد الاستعمار الأجنبي إلى إقامة دول مستقلة ومنكفئة ضمن أطر قطرية ضيقة، وغياب الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية فيها، وما ترتب على ذلك من أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية حالت دون تطور المجتمع العربي الذي أصبح عاجزاً عن الاستجابة لتحديات الإندماج في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى الديمقراطية والتفاعل مع متغيرات الحقبة الجديدة من عصرنا. تكمن الأهمية التاريخية لإنجاز الوحدة والتحول نحو الديمقراطية في اليمن، في الدروس المستخلصة من هذين الحدثين اللذين شكلا المعنى الحقيقي ليوم 22 مايو 1990م في التاريخ العربي الحديث، حيث تحقق في هذا اليوم انتقال سلمي للسلطة من التجزئة إلى الوحدة، ومن الإنفراد إلى المشاركة، ومن الشمولية إلى التعددية.. ولم يكن لكل ذلك أن يتأسس لولا تحقيق الوحدة عن طريق الديمقراطية، وهو ما يفسر فشل كافة المشاريع القومية الوحدوية التي لا تستوعب الديمقراطية ضمن منظومة منطلقاتها النظرية وأدواتها ومناهجها العملية.الثابت أن التحول نحو الديمقراطية لم يكن رديفاً للوحدة فحسب، بل كان شرطاً لحمايتها ولضمان تطورها اللاحق، بيد أن هذا التحول كان يحمل معه أيضاً إشكالياته التي جسدت خللاً عميقاً في منظومة الأفكار وخبرة الممارسة لدى مختلف القوى المشاركة في هذا التحول، الأمر الذي أنعكس على إضطراب الجهاز المفاهيمي للخطاب السياسي العام في بدايات التحول، وما رافقه من تناقضات وتباينات حادة في المواقف والتصورات خلال المرحلة الانتقالية التي مهدت لأول انتخابات تعددية عامة.ما من شك في أن العقدين الأخيرين من القرن الماضي شهدا تحولات جذرية وصلت ذروتها في سقوط جدار برلين وإنهيار الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية التي كانت ترمز إلى إنقسام العالم بشكل متواز، ووجود عالم ثالث بينهما، وقد أدت تلك التحولات إلى تغيير جذري في منظومة العلاقات الدولية والبنى السياسية والاقتصادية والمفاهيم والأفكار التي كان لها دور بارز في تسويق وتبرير العديد من نظم الحكم ونماذج إدارة السياسة والاقتصاد والثقافة التي كانت تستمد شرعيتها ومحدداتها من البيئة العالمية تحت تأثير أحداث وتحولات النصف الأول من القرن العشرين ، والحرب الباردة في النصف الثاني منه.على هذا الطريق كانت مبادرة الرئيس على عبدالله صالح بطرح مشروع الوحدة أثناء زيارته لعدن يوم 29 نوفمبر 1989، أحد أبرز الخيارات التي تتيح فرصاً أفضل لتشغيل ميكانيزمات إصلاح النظام السياسي في الشطر الشمالي من اليمن، باتجاه الاستجابة لتحديات التحول نحو الديمقراطية التي أضحت اتجاهاً كونياً لتطور عالم ٍ تتجه متغيراته نحو إطلاق مفاعيل التنافس السياسي والاقتصادي والثقافي ، في إطار نظام ٍ كوني جديد يتسم بالترابط والتكامل والاعتماد المتبادل بين جميع مكوناته. كان واضحاً أن القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتها الرئيس علي عبدالله صالح أدركت جيداً ضرورة بناء إطار وطني شامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة في هذه الحقبة من تطور عصرنا، باتجاه إعادة تأهيل الوطن اليمني كله للإندماج بالنظام العالمي الجديد، والاستجابة لرياح التغيير الديمقراطي بعد تسارع ايقاعات العد التنازلي للحرب الباردة أواخر الثمانينات.أقول ذلك من واقع خبرتي الشخصية أثناء مشاركتي في أعمال اللجنة السياسية المشتركة التي عقدت أول دورة لها في تعز أواخر أكتوبر 1989م برئاسة الأخوين د. عبدالكريم الإرياني وزير خارجية الشطر الشمالي آنذاك وسالم صالح محمد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي آنذاك أيضاً.الجدير بالإشارة أن تلك اللجنة التي تشكلت بموجب بيان طرابلس عام 1972م، هي اللجنة الوحيدة التي لم تعقد أي اجتماع لها، بعكس لجان الوحدة الأخرى التي كانت تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وكان لافتاً للنظر أن الرئيس علي عبدالله صالح هو الذي طلب من علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني آنذاك، تفعيل هذه اللجنة، وقد حضر جانب الشطر الجنوبي هذا الاجتماع بدون أية أوراق جاهزة.وكان مفاجئاً لجانب الشطر الجنوبي ما طرحه الدكتور الإرياني في الجلسة الافتتاحية حيث جاء بورقة جاهزة ومتماسكة، اقترح فيها أربعة بدائل لتفسير المادة الدستورية التي تنص على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً في مشروع دولة الوحدة التي لم يكن هناك أي تفكير جدي بها وبموعد قيامها في إطار اللجان الوحدوية المشتركة ، سوى صياغة مشاريع القوانين على ضوء الاتجاهات الرئيسية التي حددها اتفاق القاهرة وبيان طرابلس في أوائل السبعينات.لم يستغرق اجتماع اللجنة السياسية المشتركة أكثر من جلستين تم خلالها الاتفاق على عقد دورة أخرى في ديسمبر 1989م لإقرار أحد هذه الخيارات، وأشهد بحكم أنني كنت مقرراً لهذه اللجنة إلى جانب الزميل الدكتور أحمد الأصبحي بأن جانب الشطر الجنوبي لم يـُعط هذه القضية اهتماماً جاداً لأن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي كانت قد حسمت في دورتها المنعقدة أواخر سبتمبر 1989م ، المناقشات التي دارت في صحافة الشطر الجنوبي حول ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي في ضوء المتغيرات التي شهدها الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية في النصف الثاني من الثمانينات. . وبوسع أي باحث موضوعي أن يقرأ وثيقة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في تلك الدورة ليكتشف غلبة النزعة المحافظة التي وضعت الحزب والنظام السياسي في الشطر الجنوبي قبل الوحدة ضمن منظومة الدول والنظم العربية التي كانت عصية على إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية باتجاه التحول إلى الديمقراطية والإقتصاد المفتوح .. فقد شددت الوثيقة على ما أسمته (( ضرورة ألاّ يؤدي تصحيح الاختلالات في عمل هيئات الدولة والاشكال الاقتصادية إلى توسيع دائرة العوامل المولدة للعلاقات الرأسمالية)) ، كما أكدت تلك الوثيقة أيضاً على (( ضرورة مواصلة استكمال مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الآفاق الاشتراكية ))، مشيرة إلى أن ذلك (( لا يتعارض مع السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاعات معينة ضمن سقوف محددة لا تضر بالدور القيادي للقطاع العام والقطاع التعاوني)).. ولذلك جاءت الوثيقة خالية من أية ميول للانتقال إلى اقتصاد السوق وتوسيع دائرة المشاركة في الحياة السياسية، حيث رفضت اللجنة المركزية بحزم الأفكار التي دعت إلى التعددية الحزبية وحرية إصدار الصحف واعتبرتها خروجاً صريحاً عن الخط الطبقي والأيديولوجي لبرنامج الحزب الاشتراكي اليمني الذي أقر عام 1978. ولا نبالغ حين نقول أن إعادة بناء السياسة الخارجية السوفييتية التي طبقتها بريسترويكا غورباتشوف أفرزت تراجعا ملحوظا لإهتمام الإتحاد السوفييي بحلفائه الأيديولوجيين الذين أصبحوا يشكـّلون عبئاً عليه.وقد توقف تماماً الخط الساخن بين القيادة السوفييتية وقيادة الحزب الإشتراكي اليمني ، حيث تجاهلت القيادة السوفييتـية الرد على طلب علي سالم البيض الأمين العام للحزب الإشتراكي زيارة موسكو طوال الفترة (1988 / 1989م ) بعد أن فجرت البريسترويكا السوفييتية مناقشات ساخنة في عدن .وكان السفير السوفييتي في عدن البرت راتشكوف عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي وموالياً للجناح المحافظ الذي يناهض سياسة البريستيرويكا التي كان يقودها غورباتشوف ويعـتبرها خطراً على الإشتراكية الستالينية ، وقد أدّى ضعف العلاقة المباشرة بين القيادتين ، الى تزايد فرص تأثير السفير السوفييتي المحافظ على المناقشات التي كانت تدور داخل الحزب الإشتراكي اليمني ، حيث تم حسمها لصالح التيار السكولاستي المدرسي في الحزب الإشتراكي اليمني الذي كان يمثله حملة الدكتوراة وحفظة النصوص من خريجي المدارس الحزبية السوفييتية من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ومعظمهم لم يكن يحمل شهادة الثانوية العامة !! .على أن أطرف ما جاء في هذه الوثيقة من إصلاحات، أنها سمحت للاستثمارات الخاصة في قطاعين فقط وهما الأسكان بشرط أن يرخص للمستثمر ببناء عمارة واحدة فقط لسكن عائلته مع السماح له بتأجير شقتين فيها لا غير، أو الاستثمار في قطاع انتاج الدواجن بشرط إلا يزيد إنتاج المزرعة عن عشرة الأف بيضة في اليوم الواحد، وفي حالة الزيادة تتم مصادرة الإنتاج الفائض لصالح مزارع الدولة عقابا للمستثمر على زيادة الإنتاج !! أما في الجانب السياسي فقد اكتفت الوثيقة بالتأكيد على ضرورة إشاعة أجواء النقد والعلنية في عمل ونشاط هيئات الحزب ومجلس الشعب الأعلى ومجالس الشعب المحلية والمنظمات الجماهيرية، وتشجيع المناقشات والانتقادات الموضوعية في صحافة الحزب والدولة والمنظمات الجماهيرية ( راجع وثيقة الإصلاح السياسي والإقنصادي / اكتوبر 1989 م - دار الهمداني للطباعة والنشر - عدن ) . كشف إقرار هذه الوثيقة عن صعوبة استجابة الحزب الاشتراكي والنظام السياسي في الشطر الجنوبي من الوطن لتحديات التحول نحو الديمقراطية، وعجزه عن القراءة العميقة للمتغيرات الدولية.. ويمكن القول أن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح بطرح مشروع الوحدة خلال زيارته لعدن يوم 29 نوفمبر 1989 والقبول المفاجئ لهذا المشروع من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني أثناء تشاورهما المنفرد في اللحظات الأخيرة تحت نفق جولدمور بالتواهي، بعد أن كان الرئيس علي عبدالله صالح قد أصدر توجيهاته لأعضاء وفده المرافق له بالاستعداد للتوجه إلى المطار قبل منتصف الليل بسبب عدم التوصل إلى نتائج مشجعة، إن كل ذلك أسهم في إحداث نقلة مفاجئة للحزب إلى بيئة سياسية وفكرية جديدة لم يكن قد تهيأ واستعد لها جيداً، كما هو الحال في الشطر الشمالي من الوطن. في حين كانت بيئة الحزب السياسية والفكرية تعاني من انسداد خطير أضافت إليها النتائج المأساوية لأحداث 13 يناير 1986 ظلالاً ثقيلة. الأمر الذي انعكس على أداء وسلوك الحزب الاشتراكي بعد تحقيق الوحدة اليمنية وميلاد الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 الذي يؤرخ لقيام أول نظام سياسي ديمقراطي تعددي منذ تأسيس النظام الجمهوري في شطري البلاد ( 1962/ 1967) ، بقدر ما يؤرخ لميلاد أول تجربة إئتلافية حزبية في تاريخ البلاد، انتقل فيها كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني من وضع الحزب السياسي الوحيد في قمة السلطة إلى وضع الحزب المشارك ، وهو ما سنتاوله في العدد القادم بإذن الله .[c1]نقلا عن / صحيفة ( 26 سبتمبر )[/c]