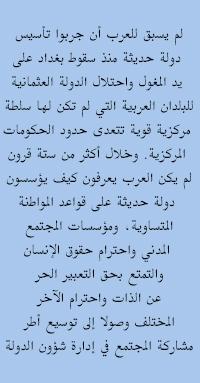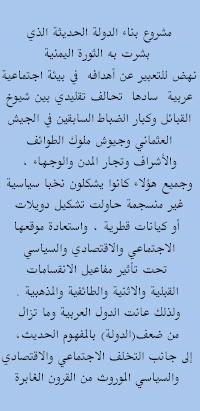لليمن .. لا لعلي عبدالله صالح
أثارت واقعة قيام أحد القضاة بتوثيق عملية بيع وشراء إنسان مستعبد في محافظة حجة، جدلا واسعـا على الصعيدين الداخلي والخارجي، لجهة الكشف عن مأساة وجود الرق والعبودية في اليمن على تخوم العقد السادس من عمر الثورة اليمنية، الأمر الذي يشكل ــ من الناحيتين النظرية والعملية ــ انحرافـا سافرا عن مبادئ الثورة اليمنية وأحكام الدستور وقيم النظام الجمهوري الديمقراطي.والثابت أن قرار انضمام اليمن إلى المعاهدة الدولية لتحريم الرق كان في صدارة القرارات الأولى التي أصدرها مجلس قيادة الثورة بعد يومين من قيام الثورة اليمنية في أواخر سبتمبر 1962م ، وهو ما أفسح المجال أمام المملكة العربية السعودية الشقيقة لاتخاذ قرار مماثل في منتصف شهر أكتوبر 1962، حيث كانت اليمن والسعودية هما الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا الانضمام إلى المعاهدة الدولية لتحريم الرق ، تحت تأثير موقف رجال الدين الذين عارضوا التوقيع على هذه المعاهدة وغيرها من المعاهدات الدولية بذريعة أنـها مخالفة للشريعة الإسلامية.مع العلم أن رجال الدين في كل العالم الإسلامي كانوا أيضا قد رفضوا التوقيع على هذه المعاهدة بذريعة أنها جزء من التشريعات الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية، بيد أن تأثير رجال الدين في اليمن والسعودية كان أقوى من تأثير زملائهم على النظم الحاكمة في بقية بلدان العالم العربي والإسلامي .!!وبصرف النظر عن الموقف الضعيف والملتبس للقاضي هادي حسن أبو عساج أثناء دفاعه عن نفسه في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة ( المصدر ) في عددها رقم 122 الصادر يوم الثلاثاء 29 يونيو 2010م ، ضد قرار مجلس القضاء الأعلى بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق بعد تورطه بتوثيق بيع وشراء أحد المواطنين اليمنيين ، فإننا لسنا بصدد مناقشة مزاعم القاضي الموقوف بأن السلوك الذي قام به لا يخالف الشريعة الإسلامية، حيث سنعود إلى مناقشة هذه الإشكالية في مقال لاحق، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن القاضي هادي حسن أبو عساج لم يكن وحيدا في التورط بإضفاء الشرعية الدينية على أسواق النخاسة في اليمن، بل إن ثمة طابورا طويلا من القضاة اليمنيين سبقوه في هذا الفعل الآثم، حيث اتضح أن العبودية لا تزال باقية في بعض المحافظات، وأن بعض مشايخ القبائل لا يزالون يمتلكون ويتوارثون ويبيعون ويشترون العبيد والجواري بعد ثمانية وأربعين عامـا من قيام الثورة والجمهورية، الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه الثورة اليمنية المعاصرة في مجرى بناء دولة وطنية حديثة على أسس دستورية وقانونية .ثمة من يرى في استمرار علاقات الاستعباد والاسترقاق في اليمن انعكاسـا لضعف سلطة الدولة وغيابها عن بعض المناطق التي اتضح أن أسواق النخاسة لا تزال باقية فيها .. بيد أن هذه الحقيقة وإن كانت مريرة ينبغي أن تتحول إلى حافز لمقاربة أسباب وجود اختراقات للإرهاب أو العبودية في المناطق التي تكون فيها الدولة غائبة ، لتحل بدلا عنها سلطة أشكال ما قبل الدولة. بمعنى أنه لا يمكن فصل الفراغات أو الاختراقات في بعض المناطق التي تغيب عنها أو يضعف فيها وجود الدولة، عن المصاعب والتحديات التي حالت دون سد فراغات واختراقات استهدفت القضاء على الثورة اليمنية وإسقاط النظام الجمهوري وإشعال نيران الحروب الأهلية وتمزيق وحدة الوطن وإجهاض مشروع الدولة الوطنية المدنية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مفاعيل هذه التحديات لا تزال تمارس تأثيرها الضاغط على مشروع بناء الدولة الحديثة الموحدة من خلال الكلفة العالية التي تدفعها البلاد بسبب مخاطر انتشار بؤر التطرف والتوتر والنزاعات الداخلية.وبوسعنا القول إن مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة لا يواجه هذه المصاعب في اليمن فقط ، بل في كثير من البلدان العربية التي تعيش أوضاعا مركبة ومعقدة تواجه تحديات التنمية والسلم الأهلي، في ظل وجود صراعات داخلية تغذيها نزعات قبلية وعشائرية ملتبسة بمشاريع راديكالية ذات طابع سياسي أو ديني، وبتأثير هذه الأوضاع يتمحور الدور المركزي للدولة العربية عمومـا حول العاصمة أو عدد محدود من المدن والحواضر بعيدا عن عملية الاندماج الوطني، فيما تبقى الصحاري والمناطق القبلية والبدوية أطرافـا شبه مستقلة عن مركز الدولة ومؤسساتها التي تعجز بسبب هذا الوضع عن التمدد إلى المدى الذي يسمح لها بتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع ، وإيجاد بيئة سياسية وثقافية وقانونية وأمنية تساعد على إدارة شؤون الدولة من خلال سلطة الدستور ومبادئ المواطنةالمتساوية بما هي تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه، حيث من شأن إهمال قيم المواطنة ضعف الشعور بالانتماء الوطني، وبالتالي مضاعفة مصاعب بناء الدولة الوطنية، وحرمان المواطنين من التمتع بحقوق المواطنين المتساوية بعيدا عن أي تمييز بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب وما يترتب على ذلك من إهدار لحقوق الإنسان بما هي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.ما من شك في أن مشروع بناء الدولة الحديثة الذي بشرت به الثورة اليمنية نهض للتعبير عن أهدافه في بيئة اجتماعية عربية سادها تحالف تقليدي بين شيوخ القبائل وكبار الضباط السابقين في الجيش العثماني وجيوش ملوك الطوائف والاشراف وتجار المدن والوجهاء ، وجميع هؤلاء كانوا يشكلون نخبا سياسية غير منسجمة حاولت تشكيل دويلات او كيانات قطرية، واستعادة موقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تحت تأثير مفاعيل الانقسامات القبلية والاثنية والطائفية والمذهبية . ولذلك عانت الدول العربية وما تزال من ضعف (الدولة) بالمفهوم الحديث، الى جانب التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الموروث من القرون الغابرة. ومن نافل القول ان العرب لم يسبق ان جربوا تأسيس دولة حديثة منذ سقوط بغداد على يد المغول واحتلال الدولة العثمانية للبلدان العربية، التي لم تكن لها سلطة مركزية قوية تتعدى حدود الحكومات المركزية. وخلال اكثر من ستة قرون لم يكن العرب يعرفون كيف يؤسسون دولة حديثة على قواعد المواطنة المتساوية، ومؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان والتمتع بحق التعبير الحر عن الذات واحترام الآخر المختلف وصولا الى توسيع أطر مشاركة المجتمع في إدارة شؤون الدولة . في هذا السياق يمكن القول إن الوعي الديني والاجتماعي و السياسي لم يدفع العرب الى توحيد انفسهم في دولة وتشكيل وحدة سياسية تستقطب مشاعرهم وانتماءاتهم وولاءاتهم ، وتوحدهم في هوية قومية واحدة، مما ادى الى نمو نزعات محلية وطائفية في المدن وعصبيات عشائرية في الأرياف، الأمر الذي يعكس حالة التخلف والركود الحضاري التي تعيشها اغلب المجتمعات العربية ، ناهيك عن عدم وجود مجتمعات متماسكة و متكاملة. حيث كان الافراد ينقسمون في فترة الحكم العثماني الاستبدادي الى رعايا وليس مواطنين والى افراد ينتسبون الى قبائل و طوائف ومذاهب ومناطق وينقسمون بدورهم الى بدو وريفيين وحضر. وهو ما يعني عدم وجود دولة او دول مركزية بالمعنى الحديث للكلمة. كما لم يكن الدين او العروبة من المحددات الرئيسية لتوحيد الناس في هوية وطنية واحدة. وهو ما يفسر إلى حد بعيد اشكالية وضعف “ الدولة” وعدم نضجها ، بحيث بقيت (العصبية القبلية) كنقيض للدولة الحديثة ، واستمرت كبنية مؤسسية سلبية وملتبسة ، بحسب رؤية المفكر البحريني محمد جابر الانصاري، في كتابه الشهير (تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية ــ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1994ــ ص82 - 83) ، فيما استمر دور العشيرة والعائلة والطائفة في الحياة السياسية والاقتصادية كضمانة لها في توفير الامن والحماية للفرد والجماعة بدلا عن الدولة التي لم تستكمل شروط قيامها. ولهذا بقي مفهوم الدولة بمعناه الحديث من اكثر المفاهيم غموضا والتباسا في الوعي الاجتماعي العربي، ويعود ذلك الى ضعف هيبة الدولة ، بالاضافة الى عوامل سياسية وثقافية ترتبط تاريخيا بالتكوينات الاجتماعية ـــ السياسية وبخاصة مؤسسة القبيلة والنظام الابوي البطريركي ، مع الأخذ بعين الاعتبار ان التاريخ العربي الاسلامي هو تاريخ صراع مستمر بين الدولة المركزية الامبراطورية من جهة، وبين القبيلة والطائفة والجماعات المحلية والمذهبية وعصبياتها من جهة اخرى. في هذا السياق تعلمنا كتب التاريخ العربي والاسلامي أن عائلات حاكمة قامت على العصبية والقوة والغلبة، وقفت على رأس هرم السلطة من الأمويين حتى العثمانيين. وقد دعا الفقهاء الى الخضوع لحكم الملوك والسلاطين الذين يستولون على السلطة بالقوة والغلبة وعلو الشوكة. وبحسب المفكر والمؤرخ العراقي علي الوردي تعد المجتمعات العربية من اكثر المجتمعات في العالم تأثرا بالقيم والتقاليد والعصبيات البدوية في محاسنها ومساوئها.( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، بغداد 1965، ص 15 - 16) .ولما كان مفهوم الأمة الاسلامية ـــ وليس الدولة ـــ يشكل مركز الثقل في تشكيل الوعي الاجتماعي عند العرب والمسلمين فقد أصبح الوعي السياسي العربي موزعاً بين الولاء للعصبية القبلية او المحلية او الطائفية، وبين الولاء للعصبية الدينية والمذهبية التي تعوض عن الولاء القبلي والمحلي والطائفي، أي التماهي بها. وبهذا يصبح الولاء للعصبية هو البديل عن سلطة مركزية قوية وقادرة على حماية الفرد. ولعل ما يؤكد ذلك هو ان الدولة في المجتمع العربي والاسلامي لم تكن محور العلاقات الاجتماعية، وانما كانت ولا تزال مجرد وسيط خارجي لتحقيق المصالح. وفي حالة تحطيم هذا الوسيط تفقد الجماعة واسطة عقدها ومركز توازنها كجماعة سياسية. (برهان غليون، النظم الطائفية من الدولة الى القبيلة، بيروت 1990، ص 136) تأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م دشن بداية عهد تاريخي جديد في مسار الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة للشعب اليمني، إذ جاء الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية لينهي عقوداً من التجزئة والتشطير والتوترات الداخلية ، التي تركت ظلالاً ثقيلة على شكل ومضمون الحراك السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي للمجتمع اليمني . وزاد من أهمية توحيد الوطن سلمياً ارتباطه بولادة أول نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يتيح ظروفاً أفضل لتشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق الحريات المدنية وإقرار مبدأ سيادة الأمة وضمان حقها في انتخاب هيئات السلطة بواسطة الاقتراع الحر والمباشر على طريق تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة. لا تسعى هذه السطور إلى البحث في تاريخ التحول نحو الديمقراطية في بلادنا منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، بقدر ما تستهدف مقاربة مصادر الخلل والتناقضات والأزمات التي حدثت في مجال ممارسة السياسة على مستوى الدولة والسلطة والمجتمع.. ولا ريب في أن إجراء هذه المقاربة ضروري كخطوة على طريق البحث عن آليات معرفية لإعادة بناء الفكر السياسي في اليمن، وتجاوز الإشكاليات والمصاعب الناجمة عن حداثة التحول نحو الديمقراطية، وهي إشكاليات ومصاعب لا يمكن فهمها من خلال النظرة التبسيطية التي تختزلها في تناقض مفترض بين سلطة تنزع إلى تقييد الممارسة الديمقراطية، ومعارضة نذرت نفسها للدفاع عن الديمقراطية ونظامها القيمي. من نافل القول أن إعلان قيام الوحدة وتدشين التحول نحو الديمقراطية تحققا بإرادة سياسية مشتركة من قبل قيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني اللذين كانا يحكمان شطري البلاد قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م .. ولا يقلل ذلك من أهمية الدعم الواسع الذي قدمه الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية ومنظماته الجماهيرية لهذا المشروع الوطني التاريخي .. بمعنى أن القوى المحركة لهذا المشروع سواء على مستوى النخب الحزبية الحاكمة في شطري البلاد قبل الوحدة، أو على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية، كانت ومازالت تنتمي إلى منظومات فكرية وسياسية متعددة ومتباينة، لكل منها جهازه المفاهيمي الذي يشكل وعيه ورؤيته ومواقفه واستعداداته في مختلف القضايا المتعلقة بإدارة شئون الدولة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، بما في ذلك طريقة فهمه للعالم الخارجي. ثمة من يقول إن توافق الإرادة السياسية لقيادتي الشطرين سابقاً في تبني مشروع الوحدة والديمقراطية لم يكن بعيداً عن العوامل المؤثرة في البيئة الإقليمية والعربية المحيطة باليمن، حيث وصلت الدولة القطرية إلى ذروة أزماتها المتمثلة بالعجز عن مواصلة التنمية التي اصطدمت بعدة عوائق أهمها فشل نماذج الاقتصاد الموجه والاقتصاد الاشتراكي في بعض البلدان العربية، وغياب الحريات السياسية والمدنية في بلدان عربية أخرى أخذت بنظام اقتصاد السوق، بالإضافة إلى مأزق الانكفاء داخل حدود الدولة القطرية. ويربط أصحاب وجهة النظر هذه بين تزامن أزمات التنمية والديمقراطية في العالم العربي من جهة، وبلوغ الأزمة الاقتصادية في البلدان الاشتراكية ذروتها بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومة الاشتراكية الدولية من جهة أخرى، إلى جانب التحول التدريجي للصين من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر والاقتصاد المزدوج . ما من شك في أن تزامن إعلان قيام الوحدة مع التحول الديمقراطي شكل إسهاماً يمنياً متميزاً في إثراء الجدل الذي ساد في أوساط النخب السياسية والفكرية العربية خلال الثمانينات، حول إشكاليات تحقيق الوحدة العربية وحاجة المجتمع العربي للديمقراطية ، بعد أن وصلت مسيرة الكفاح التحرري الوطني ضد الاستعمار الأجنبي إلى إقامة دول مستقلة ومنكفئة ضمن أطر قطرية ضيقة، وغياب الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية فيها، وما ترتب على ذلك من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حالت دون تطور المجتمع العربي الذي أصبح عاجزاً عن الاستجابة لتحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى الديمقراطية والتفاعل مع متغيرات الحقبة الجديدة من عصرنا. تكمن الأهمية التاريخية لإنجاز وحدة الوطن اليمني أرضاً وشعباً ، والتحول نحو الديمقراطية ، في الدروس المستخلصة من هذين الحدثين اللذين شكلا المعنى الحقيقي ليوم 22 مايو 1990م في التاريخ العربي الحديث، حيث تحقق في هذا اليوم انتقال سلمي للسلطة، من التجزئة إلى الوحدة، ومن الانفراد إلى المشاركة، ومن الشمولية إلى التعددية.. ولم يكن لكل ذلك أن يتأسس لولا تحقيق الوحدة عن طريق الديمقراطية، وهو ما يفسر فشل كافة المشاريع القومية الوحدوية التي لا تستوعب الديمقراطية ضمن منظومة منطلقاتها النظرية وأدواتها ومناهجها العملية .. وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله .[c1]*عن / صحيفة ( 26 سبتمبر )[/c]